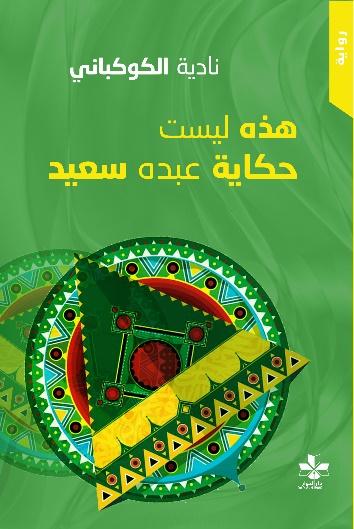 هذه ليست حكاية عبده سعيد: هذه حكايتنا جميعًا
هذه ليست حكاية عبده سعيد: هذه حكايتنا جميعًا
رياض الحَمَّادي
يبدأ عنوان رواية نادية الكوكباني "هذه ليست حكاية عبده سعيد"- الصادرة عن دار الحوار (2024)- باشتباك أول/ مباشر مع القارئ، ينفي أن تكون الحكاية فيها هي حكاية عبده سعيد. سيتساءل القارئ: حكاية من إذن؟ ومن هو عبده سعيد؟ وبذلك تكون الرواية قد ضمنت عنصر التشويق منذ عتبتها الأولى (العنوان).
الحكاية الأهم
القارئ لروايات نادية الكوكباني السابقة: "صنعائي" و"سوق علي محسن" سيتذكر عبده سعيد. ذلك الرجل الذي ادعى الجنون واتخذ من مقبرة خزيمة مسكنًا له. وسنعرف في هذه الرواية أنه أحد المناضلين الذين صنعوا ثورة سبتمبر ثم دافعوا عنها وبذلوا في سبيل ذلك حياتهم. عبده سعيد في سياق الرواية هو رمز لكل مناضل، والحكاية إذن هي حكاية أولئك الثوار الذين حفظنا أسماء بعضهم فيما غابت أسماء أخرى بانسحاب ذاتي من المشهد أو غُيِّبت بفعل الإخفاء القسري الذي ستخصص له الرواية فصولًا كاملة.
علاقتنا بعبده سعيد، في رواية "صنعائي"، تبدأ منذ قدوم صُبحية إلى المقبرة، برفقة شقيقها ووالدتها، لدفن جثمان والدها المناضل جبران الذي أوصاهم بدفنه في مقبرة خزيمة؛ معللًا السبب بأنها "قلب صنعاء الذي لن يتوقف عن النبض، طالما يشهد نهاية حيوات مرت بتاريخ المدينة وتحولاتها، وأن صنعاء لم تغادر قلبه وهو حي، ولا يريد أن يغادر قلبها وهو ميت".
إذا كانت خزيمة شاهدة على تحولات المدينة فثلاثية "صنعائي" شاهد آخر على تحولات اليمن ككل من خلال ثيمة الثورة، برصد إخفاقاتها وتتبع مآلاتها. هذه الأجزاء الثلاثة يمكن أن تُقرأ منفصلة، كما أن نهاياتها المفتوحة واعدة بمزيد من الأجزاء.
تواصل الكوكباني في هذا الجزء سرد حكاية عبده سعيد، بالعودة إلى جذوره: طفولته ومراهقته وشبابه، وتتخذ من الرسالة تقنيةً سردية تمنح الحكاية بعدًا شخصيًا وحميمًا، وتُتيح للراوي أن يكشف ذاته وتحوّلاتها عبر خطاب موجَّه في الظاهر لصبحية، وفي الجوهر هو خطاب موجه للقارئ. يشرح عبده سعيد، في هذه الرسالة الطويلة، دوافع تتبعه لصبحية، ويحكي لها جزءًا غامضًا من تاريخ أبيها. ومن خلال هذا الخطاب سيتعرف القارئ على ثلاث مدن: عدن وتعز وصنعاء. وثلاث نساء: منتهى، بدور، ونعمة. إضافة إلى نساء ورجال آخرين يشاركون في سرد تفاصيل هذه الرواية الحافلة بالتفاصيل الدقيقة والأحداث. نحن هنا أمام رواية يمكن تقسيمها إلى ثلاث روايات قصيرة: رواية عدن، ورواية تعز ورواية صنعاء. والأهم من تعرُّف القارئ على جزء من تفاصيل كل مدينة وروحها والقرب من نسائها ورجالها، هو تعرفه على التاريخ الثوري لهذه المدن. تسرد رواية "صنعائي" جزءًا يتعلق بثورة 26 سبتمبر 1962، وما تلاها، وتسرد رواية "سوق علي محسن" أحداث ثورة 2011، وتركز هذه الرواية على إرهاصات ثورة 26 سبتمبر ومسارها وتلمح إلى الأسباب التي أدت إلى إخفاقها.
هذه الرواية إذن هي حكاية المدينة والثورة والمرأة اليمنية. بهذا يجوز أن نسمي هذه الرواية "قصة ثلاث مدن"- على غرار "قصة مدينتين" لتشارلز ديكنز-؛ إذا كنا سنركز على قصة المدينة، و"قصة ثلاث نساء" إذا كنا سنركز على روح المرأة اليمنية خاصة والمرأة بشكل عام؛ بحكم أن منتهى هندية/هندوسية الجذور ويمنية الهوى والروح، وصوفية الديانة. منتهى التي صار قلبها قابلًا كل صورة: فمرعىً لغزلانٍ، ودير لرهبانِ وبيتٌ لأوثانٍ، وكعبة طائفٍ، وألواح توراةٍ، ومصحف قرآنِ، تدين بدين الحب أنَّى توجهتْ ركائبه فالحب دينها وإيمانها. منتهى التي صهرتها عدن بطابعها الكوزموبوليتاني/العالمي، يوم كانت عدن وطنًا ودينًا لكل من يحل فيها.
لكن، لأن الرواية تغوص أكثر في طبقات التاريخ فقد استحقت أن يكون عنوانها "هذه ليست حكاية عبده سعيد"، لتشير بهذا العنوان إلى حكاية أهم، هي حكاية الثورة التي أضعناها، والوطن الذي فقدناه، وكأنها بهذه الإشارة العنوانية وهذه الحكاية الطويلة- بل الحكايات- تقدم لنا وصفة لعلاج الحاضر وتمنحنا أملًا بمستقبل أجمل.
المرأة والمدينة
تغزل نادية الكوكباني سرديتها هذه بروح ومزاج نسَّاج صبور. تماما مثلما تطرز "بُدور" ملابس النساء بمهارة جعلتها حديث المدينة. ولعل دراسة الروائية للهندسة المعمارية وتدريسها لها- فهي تحمل شهادة الدكتوراه فيها- قد أثر إيجابيًا على سردها. تأثير المهن على الروائيين يظهر في سردهم. ومهنة الروائي الأولى تظل عالقة في لغته، حتى إن كان قد تخلى عنها وتفرغ للكتابة، تظل مهنته الأولى مؤثرة في تشكيل الجملة: مفرداتها، وإيقاعها. المهنة ليست مجرد جزء من سيرة الروائي، بل هي طبقة خفية تُطعّم كتابته بإيقاعات داخلية، أخلاق مضمَرة، ومنظور يرى الحياة من زاوية معيّنة. وتفتح أبوابًا للأسئلة: كيف ينظر الروائي إلى الزمن؟ كيف يتعامل مع الألم؟ من يملك السلطة في نصه؟ وما الحكاية التي يختار أن يحكيها؟
أنطون تشيخوف كان طبيبًا، وقد ظهرت حساسيته الطبية في فهمه العميق للضعف الإنساني، وأسلوبه المراقب، وكأنما يعاين الشخصيات كما يعاين مريضًا. ويليام فوكنر بدأ حياته نجّارًا وعمل جون شتاينبك في مزارع وورش ومهن لها علاقة بالأرض: في الحصاد والزراعة وترميم المباني، وقد تركت هذه المهن أثرها في أعمالهما السردية. ولأن خوسيه ساراماجو عمل في سنّ مبكرة ميكانيكيًا، فقد علمته الميكانيكا أن كل شيء قابل للإصلاح، حتى اللغة، يمكن أن تتعطل ويمكن إصلاحها. اللغة عند كاتب عمل في ورشة نجارة، ستشبه الخشب، يمكن أن تُقطع وتُشكل وتُصقل، والروائي الذي عرف يومًا كيف يُشكل الفخار من الصلصال، سيعرف كيف يبني شخصياته ويعيد خلقها. هكذا، ستكون اللغة في روايات جبرا إبراهيم جبرا بصرية، لأنه كان رسّامًا قبل أن يكون روائيًا. فإن تتبعت سيرة المهن الأولى في حياة الروائيين ستجد تأثيرها على نصوصهم. وهذا مبحث مستقل يمكن دراسته في مقالات أخرى ومنها مادة عن تأثير الهندسة المعمارية في بناء وتشكيل نصوص نادية الكوكباني. وقد تطرقت إلى شيء من هذا في مقالة لي بعنوان "سيرة المكان في رواية صنعائي".
تتوقف الكوكباني عند أبواب المدن الثلاث وتطرقها بعبارات تلخص روح نسائها فتوحد بذلك بين المرأة والمدينة وتصبح المرأة مدينة والمدينة امرأة. تطرق بوابة عدن بعتبة تفتتح به حكاية المدينة ونسائها وثورتها:
"إذا ما رضت عنك المرأة العدنية منحتك عبقها، وإذا ما غضبت عليك دسَّت في فمك ملح بحرها ومضت لحالها." وتطرق بوابة تعز بعبارة: "إذا رضت عنك المرأة التعِزِيَّة عملت بالنيابة عنك، وجعلت منك ملكًا متوجًا على قلبها.. فإذا ما غضبت عليك، ألقت بك في وجه الريح ومضت لحال سبيلها." وأمام بوابة صنعاء تقول: "إذا رضت عنك الصنعانية، وهبتك كل ما تملك، وإذا غضبت منك سلمت أمرها لله ومضت لتنجو بذاكرة مثقوبة."
لا تكشف هذه العبارات عن أنماط شخصية المرأة اليمنية في كل زمان ومكان، لكنها تكشف عن جوهر شخصيات الرواية الثلاث، في الوقت الذي تحاول القبض الإيجابي على روح كل امرأة في هذه المدن، لنكون أمام ثلاث مدن صامدة وثلاث نساء قويات.
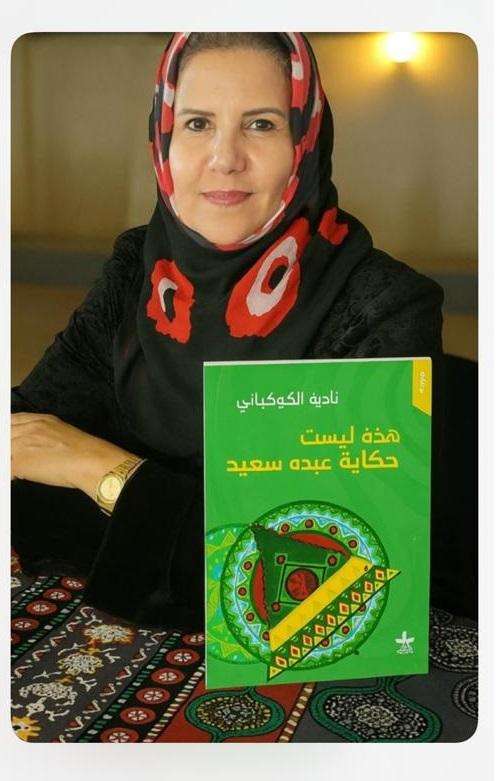
رجل مجنون يبشر بالثورة
ستُذكرنا هذه الرواية بوصية جبران. توفى جبران في القاهرة، "المدينة التي أرادها أن تكون منفاه الاختياري ليقضي فيها بقية حياته بعد أن غادر صنعاء في أواخر عام 1972، مصطحبًا زوجته وولديه." بينما يبقى رفيقه في النضال، عبده سعيد، في اليمن ليكون شاهدا على ثورة أكلت أبناءها، وبعد أن اعتقل وأخفي قسريا مع كثير من رفاقه تمكن من الهرب وعاش بقية حياته مدعيًا الجنون ليتمكن من بث روح الثورة من جديد ويتجنب اعتقاله.
يقول سعيد مبررًا هذا الفعل: "أصبح الجنون هو حريتي التي فقدتها منذ زمن، وسببًا محفزًا لوجودي. أستطيع به تغيير جزء يسير من ظلم وقسوة ما يدور حولي. محاولة لم أكن أعرف مدى نجاحها من فشلها لكن ما كنت موقنًا به هو ضرورة قيامي بها مهما كان الثمن."
كنا قد شاهدنا عبده سعيد في رواية "سوق علي محسن" يتجول في الشوارع حاملًا صور المناضلَين عبدالرقيب عبدالوهاب وإبراهيم الحمدي. وسيسرد هذا الجزء تفاصيل رحلة عبده سعيد وهو طفل من مسقط رأسه في قرية "الدَّيم"- "مديرية الموادم"، إحدى مديريات "جبل صَبر"، في مدينة تعز- إلى عدن، منتصف الأربعينيات، ثم عودته إلى تعز، وهو شاب، ثم سفره إلى صنعاء، وعودته أخيرًا إلى مسقط رأسه وهو شيخ مُسن. في رحلاته الثلاث كان للصدفة والقسر الدور الأساس. لكن الإكراه يتحول بفعل الإرادة والعزيمة والاختيار إلى أفعال إيجابية تسهم في صنع مصير عبده سعيد الشخصي. وفي هذا التحول من الجبر إلى الاختيار إشارة إلى الممكن في مصير الوطن (اليمن)، ورسالة مضمرة بممكنات الإنسان اليمني.
سردية الحب والثورة
في الرحلة الأولى يختطفه أبوه، وهو في السادسة من عمره، حارمًا إياه من حنان أمه. سيعيش الطفل مع زوجة أبيه في قرية "دُكيم"، منطقة قريبة من عدن. ثم تلعب الصدفة والرغبة في تحسين دخل الأب دورًا في انتقال الطفل إلى عدن، ليعمل خادمًا في فيلا سيدة عدنية، سيسميها "الست"، وستعامله كفرد من العائلة، وتعوضه عن حنان الأم، وتمنحه الثقة والتعليم ليشب في كنفها وكنف عدن، المدينة التي احتضنته وعلمته كما فعلت معه الست. هذه مطابقة مرآوية أولى بين المرأة والمدينة ستتلوها مطابقات أخرى بين ثلاث مدن وثلاث نساء هن: منتهى وبدور ونعمة.
في المدن الثلاث يتوقف عبده سعيد ليروي شطرا من سيرته وسيرة المدن والنساء في السياق الثوري. سنتعرف على روح عدن في منتصف الأربعينيات والخمسينيات، عدن المدينة الكوزموبوليتانية، العالمية العلمانية، التي تحتضن الأعراق والأديان المختلفة بكل محبة وتسامح. في عدن سيتعلم عبده سعيد أبجديات النضال الوطني، بمعية رفيقه "والي"، وبتوجيه من الأستاذ الصحفي عبدالله. سيتعرف على منتهى، فتاة من أصول هندية، تعتنق الديانة الهندوسية وتمارس طقوس الإسلام في الوقت نفسه دون أي تناقض. يبدأ حبهما بالزواج ولا ينتهي بانفصال جسديهما، بعد أن فرقهما الاحتلال، بالقبض على عبده سعيد وترحيله إلى تعز.
في تعز يواصل عبد سعيد النضال الوطني، ويساهم مع رفاقه في التحضير لثورة سبتمبر 1962م. بموت الإمام أحمد ساهمت الصدفة، أيضًا، في انطلاق الثورة من صنعاء، لكن إرهاصاتها كانت قد بدأت في تعز، وروحها نُفخت في عدن. ولأن الحب لا ينفصل عن الثورة، في ثلاثية "صنعائي"، سيتعرف عبد سعيد في قريته على بدور. تعجبه شخصيتها القوية وإرادتها الحديدية وذكائها، سيتقرب منها وستكلل محاولاته بالزواج. لكن نداء العمل الوطني يدفعه للانتقال إلى صنعاء دفاعًا عنها وفكًا للحصار الذي طوَّقها به الملكيون ومن يدعمهم من الدول الخارجية.
في صنعاء سيكون عبده سعيد شاهد عيان على الخذلان والخيانات التي تعرض لها أبطال الثورة الحقيقيين الذين لوحقوا بالقتل والنفي والتهميش، بعد فك حصار السبعين يومًا. وبعد فشل انقلاب الناصريين، في مطلع الثمانينيات، على حكم الرئيس علي عبدالله صالح، يُعتقل عبده سعيد مع رفاقه ويودع في سجن القلعة. هناك سيسرد عبده سعيد فصولًا من أدب السجون والمخفيين قسريًا. تلعب الصدفة دورها هنا أيضا ليتمكن من الفرار إلى بيت مجاور للسجن، بيت نعمة. ومن هناك سيعود إلى تعز. لكن صنعاء كانت قد أسرته ودفعه عشقه لها للعودة إليها ليفتتح مقهى. وبعد سنوات من القهر والظلم يختار عبده سعيد الجنون ليكون أداته في نشر روح الثورة بين الناس؛ فلا تتعرض له السلطات بالاعتقال مثلما فعلت من قبل.
بهذا الربط، بين الثورات الثلاث: سبتمبر وأكتوبر وفبراير، ومن خلال رحلة عبده سعيد من حاضر (2011) إلى الماضي والعكس، تنصهر الثورات في بوتقة واحدة مستمرة تحمل إشارة إلى وحدة المصير. وثمة تفاصيل كثيرة لا يمكن حصرها هنا في سياق الحديث عن ملخص الحكاية التي يمكن أن تتخذ عنوانًا آخر لها هو "سردية الحب والثورة".
ينتصر الحب دائمًا وتتعثر الثورة، لكنها لا تفشل؛ إذ تعد الرواية في ثنايا سردها بروح الأمل. يعود عبده سعيد أدراجه إلى مسقط رأسه، لكنها ليست عودة قهقرية تنم عن اليأس، بل عودة للطفولة لزراعة شجرة الحب والثورة حيث بدأت. جدير بالذكر أن الرواية تقول كل هذا بلغة التلميح وبمضامين رمزية تتسق مع فن الرواية في مفهومها العام ومع موضوعها ومضامينها في السياق الخاص بهذه الرواية.
مدن تزهر في الخريف
الرواية مقسمة إلى ثلاثة فصول، وكل فصل مقسم إلى عناوين فرعية، 85 عنوانًا تقريبًا. وثيمة الرواية: الحب والثورة، موضوعان يبدوان منفصلين، لكنهما في سياق الرواية متطابقين كعملة ذات وجهين؛ فالحديث عن الثورة هو حديث عن الحب، والعكس صحيح. وللحب هنا وجوه متعددة: حب الوطن، كمفهوم معنوي وكأرض أو جغرافيا مادية، والحب العاطفي الرومانسي بين الجنسين، وحب الحياة، وحب الناس لبعضهم. ومن خلال هذه الثيمة (الحب والثورة)، يروي عبده سعيد، قصة ثلاث "مدن تزهر في الخريف"- وهذه هو عنوان الرواية الذي وصل إلى القائمة الطويلة في جائزة كتارا- في إشارة إلى فصل الخريف الذي حدثت فيه أهم ثورتين في تاريخ الشعب اليمني، ثورتا سبتمبر 1962م وأكتوبر 1963. في الخريف تتساقط أوراق الأشجار لكن المفارقة الشعرية في عنوان الرواية ومضامينها تعكس القاعدة وتخالف الطبيعة ليصبح الخريف ربيعًا وموسمًا لإزهار المدن بالحب والثورة.
يمزج عبده سعيد الحديث عن هذه المدن بالحديث عن نسائه الثلاث: منتهى (عدن) وبدور (تعز) ونعمة (صنعاء)، تتوحد المدن في مدينة هي اليمن والنساء في امرأة. هنا أيضًا تتماهى صورة المرأة مع واقع المدن أو طبيعتها خلال الزمن الذي تدور فيه أحداث الرواية. كما تتحد النساء بحبهن لعبده سعيد، وبهذا الحب تتوحد الأرض والوطن في صورة للوحدة الوطنية، دون شعارات.
تُسرد أحداث الرواية بتقنية الرسائل، من حيث الشكل السردي، وتقنية الاسترجاع، والإسقاط؛ إسقاط الماضي على الحاضر بالانتقال من زمن الماضي القريب (2011)، إلى الماضي البعيد (1962 وما قبله)، ثم إلى الحاضر. وتُسرد الأحداث بضمير المتكلم، وهو السائد، وبلسان السارد العليم: من خلال السُّراد المشاركين، ما يمنح الرواية تعددًا في الأصوات.
تنطوي رسائل عبده سعيد على جزء غامض، بالنسبة للقارئ ولصبحية، فتتساءل عن سر اهتمامه بها وعلاقته بأبيها جبران، وبقراءتها للرسائل تأمل صبحية في معرفة سر هذا الاهتمام والرعاية الأبوية. جزء من التشويق في الرواية ينبني على هذا الغموض، وجزء آخر يتأسس على مصير الثورة وشخصوها المتخيلين وعلى مدى مخالفة الواقع المتخيل للتاريخ السياسي. وقيام صبحية بدور القارئ، داخل الرواية، ودورها الفاعل في حاضر الحكاية، أو ماضيها القريب، هو تمثيل رمزي للقراء خارجها، فتكون رسائل عبده سعيد لصبحية موجهة لقراء الرواية، ليتمكنوا من التعامل مع حاضرهم الذي لا يختلف كثيرًا عن ذلك الماضي الذي عاد أو أُعيد بمكر من أنصاره وتخاذل من خصومه.
عبده سعيد وجان فالجان
سواء وعت الكاتبة ذلك أم لا فإن الرعاية التي يوليها عبده سعيد لصبحية ذكَّرتني برعاية جان فالجان لابنته في التبني، كوزيت، في رواية "البؤساء" لفيكتور هوجو. حب جان فالجان لكوزيت جعله يُسخِّر حياته لحمياتها، لم يقف في طريق حبها، بل ظل يراقبها ويتعهدها بالرعاية بصمت وحنو. وهكذا فعل عبده سعيد حين أحبت صبحية حميد في رواية "صنعائي"، وهكذا سيفعل معها في "هذه ليست حكاية عبده سعيد".
ثمة مشهد يحمل فيه عبده سعيد صبحية أثناء أحداث ثورة 2011، يشبه مشهدا بارزًا لجان فلجان وهو يحمل حبيب ابنته، ماريوس بونمرسي، أثناء انتفاضة باريس عام 1832. يوشك ماريوس على الموت في المتاريس. لكن جان فالجان يتسلل إلى قلب الثورة. وفي لحظة بطولية مؤثرة، يحمل ماريوس الجريح على كتفيه ويهرب به عبر أنفاق الصرف الصحي، في واحد من أكثر المشاهد الرمزية والتشويق في الرواية، التي تُجسد فكرة الخلاص والتضحية.
ويلخص فصل "ظل أمين" حماية عبده سعيد لصبحية على هذا النحو: "أثناء وجود صُبحية في ساحة التغيير استمر عبده سعيد في التملص من أمام ناظريها... ما لا تعلمه صُبحية أنه لم يتوقف يومًا عن متابعتها وحمايتها في المسيرات... فعل عبده سعيد الكثير لحماية صبحية. في "جمعة الكرامة" الحزينة، استخدم جنود النظام الرصاص الحي... وجد عبده سعيد صبحية تتقدم مع صديقتها بلقيس باتجاه صوت الرصاص لإسعاف الجرحى.. غطى نصف وجهه بلثام، وسحبهما إلى أحد الأزقة.. وفي إحدى المسيرات لم تحتمل صبحية رائحة الغاز فسقطت مغشيًا عليها، وحين أفاقت وجدت نفسها في المستشفى، لم تعرف ماذا حدث لها! فقد حملها عبده سعيد وأسعفها. كان قريبًا منها كظلها."
حياة جان فالجان وعبده سعيد سلسلة من التضحيات. يحاول فالجان التكفير عن ماضيه ببناء عالم أكثر عدالة. وفي حبه لكوزيت نرى الجانب الأبوي، وفي إنقاذه لماريوس نرى أرقى أشكال نكران الذات. يظل يراقب كوزيت من بعيد، حتى بعد زواجها، دون أن يطالب بأي امتنان. وفي نهاية حياته، يموت بهدوء، بعد أن كشف الحقيقة، وقد غُسلت خطاياه بالحب والتضحية. هذا الجانب الأبوي نجده أيضًا في شخص عبده سعيد تجاه صبحية. ولا غرابة في ذلك فهي ابنة رفيقه وقد تعهد له بحمايتها، وكان قد عرفها عبر الصور منذ كانت طفلة، وفي رسائله لها يناديها: ابنتي.
اسم "عبده سعيد" شائع في مدينة تعز، هو نفسه يعلل هذا الاسم بقوله إن "معظم أبناء محافظة تعز، في ذلك الوقت، يُدعون "عبده"... و "ملامح كل "عبدو" متشابهة في القرية التي يتشارك فيها الأهالي الطعام ذاته..." ورغم شيوع هذا الاسم في الواقع إلا أنه قد ارتبط أيضًا بقصص القاص محمد عبدالولي، ويمكن أن نرى في هذا الاختيار تحية من الكوكباني لعبدالولي، التي أهدت روايتها هذه لليمن ككل، وكانت قد أهدت روايتها "صنعائي" للمناضل عبدالرقيب عبدالوهاب.
قيم الحب والزواج
للحب والزواج في الرواية قيمة أخلاقية إضافة إلى كونها علاقات عاطفية. تزوج عبده سعيد الهندية، هندوسية الجذور، في عدن، وتزوج المطلقة في تعز، والأرملة في صنعاء. ولا تخفى دلالة هذه الزيجات على القارئ. وهي دلالات اجتماعية وأخلاقية وسياسية ووطنية. وثمة دلالات سياسية عن جوهر النضال الوطني الذي يتجلى في تضحية الرجال بأنفسهم دون توقع أو انتظار مصلحة شخصية. كما تعكس الرواية شخصية المرأة في صورتها الإيجابية الفاعلة التي لم يكن دورها الاجتماعي والسياسي يقل عن الدور الذي يؤديه الرجال في هذين المجالين. لا يقتصر دور المرأة على الجانب الاجتماعي، فثمة أدوار سياسية مهمة تؤديها: مشاركتها في النضال الوطني حاضرة في شخصية الصحفية راوية ونضالها ضد المحتل، وفي شخصية المرأة التي تدعم الثوار بالمال. كما هي حاضرة في شخصية نعمة التي تؤوي الفارين من بطش المعتقل. وثمة دلالة تربط الحاضر بالماضي فتسقط الثاني على الأول، بلسان حال يقول: "ما أشبه الليلة بالبارحة". ومن خلال هذه الإشارة تحث الرواية على ضرورة مواصلة النضال بالعزيمة المخلصة نفسها التي اتسم بها عبده سعيد ورفيقه جبران وغيرهما من شخصيات الرواية. والرواية بهذه القيم الاجتماعية والسياسية تصبح أداة ثورية ووسيلة للنضال بالكلمة.
هذه ليست رواية تاريخية!
هذه الرواية تاريخية، بمعنى أنها تتخذ من التاريخ خلفية لأحداثها المتخيلة، وهي تستند إلى روح التاريخ أكثر مما تستند إلى أحداثه الواقعية. في هذه الحالة، ليس من الضروري أن تتطابق الرواية التاريخية تمامًا مع الأحداث التي وقعت في الواقع، والأمر يتوقف على نية الكاتب وجنس الرواية التاريخية الذي يشتغل عليه. إذا كانت رواية تاريخية من النوع "الواقعي/التوثيقي" مثل "سوق علي محسن": في هذه الحالة، يُنتظر من الكاتب أن يلتزم بالدقة الزمنية والمكانية والشخصيات الحقيقية، وألا يُحرّف الوقائع الأساسية (مثل تاريخ معركة، أو شخصية حقيقية ماتت بطريقة معينة). لو أن رواية "عبده سعيد" أرادت الالتزام بشخصيات التاريخ لأمكنها أن تأخذ من التاريخ صحفيًا حقيقيًا وتعطيه دور عبدالله. ولفعلت المثل مع راوية ووالي وجبران وعبده سعيد نفسه. لكن، هذه الرواية هي رواية الناس العاديين، وبطولاتهم المنسية، وفي الوقت نفسه تحيل فنيًا إلى الأدوار التي قام بها الأشخاص الحقيقيين في الواقع.
يمكن للروائي أن يتخيل تفاصيل ثانوية غير موثقة تاريخيًا (كأحاديث خاصة، أو مشاعر داخلية، أو يوميات مفترضة) بشرط ألا تتناقض مع الجوهر التاريخي المعروف. وأرى أن هذه الرواية لم تقع في هذا التناقض، ولا يعني هذا خلوها من المآخذ التي قد يجدها القارئ، والتي قد تدخل ضمن ما يسمه هنرى جيمس بأخطاء التنفيذ، وهي أخطاء يغفرها جيمس خلافًا لخطأ عدم التشبع بالفكرة، أو برؤية الرواية وما يريد الروائي قوله من خلالها. "اسم الوردة"، مثلًا، رواية تاريخية تخييلية دقيقة في خلفيتها وسياقها، تخدم الفكرة وليس الحدث، وتستخدم التوثيق التاريخي كأداة لبناء عالم متماسك فلسفيًا وجماليًا، لا كغاية في ذاته.
هناك روايات تاريخية تعيد (تأويل التاريخ) باستعمال المادة التاريخية نفسها. وفيها يكون الكاتب أكثر حرية في تعديل أو إعادة تخيّل التاريخ، ويُسمح له بتغيير النتائج أو صنع شخصيات تاريخية لم توجد قط، أو إسناد مواقف مختلفة لشخصيات واقعية. أي أن الغاية هنا هي تأويل التاريخ، كما فعل محمد الغربي عمران في رواية "ملكة الجبال العالية" التي عنونها فيما بعد بـ "مملكة الجواري" وفيها أعاد استنطاق تاريخ الملكة أروى بنت أحمد الصليحي: لماذا طالت فترة حكمها؟ وما سر مقتل زوجها وابنيها؟ يستخدم عمران الإطار التاريخي كقناعٍ فني للحديث عن الحاضر: عن السلطة، القمع، التديّن الزائف، تسييس الدين، وواقع المرأة. التاريخ في الرواية ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لقول أشياء لا يمكن قولها مباشرة في الحاضر. وهذا ما يفعله الغربي في كل رواياته التاريخية: يستعير التاريخ ليقول ما لا يمكن قوله عن الحاضر.
هناك روايات تاريخية من النوع "التخييلي/البديل"، تسعى إلى فتح باب: "ماذا لو؟"؛ ماذا لو لم تُهزم الدولة الفاطمية؟ ماذا لو لم يُقتل عمر المختار؟ إلخ. مثل: رواية "الرجل في القلعة العالية" (التي تتخيل فوز النازيين في الحرب العالمية الثانية).
خلاصة: الرواية التاريخية، كما نعلم، ليست درسًا في التاريخ، والرواية التي بين أيدينا لا تهدف إلى إعادة كتابة التاريخ، بل هي تأملٌ فني فيه أو إعادة تخييل له. ما يُطلب من الروائي، في هذه الحالة، هو الأمانة الجمالية، لا الأمانة الأكاديمية، إلا إذا ادّعى الثانية.